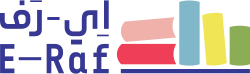سلة التسوق الخاصة بك فارغة الآن.

سنة الإصدار : 2021
إن قانون أي أُمة هو مرآة أحوالها المادية والفكرية والاجتماعية، وإذا كان من المفترض أن يكون القانون هو مصدر سعادة كل مُجتمع ونهضته كما يقول فلاسفة القانون فإنه لن يكون كذلك إذا لم يُحقق متطلباتهم وآمالهم الثقافية والفكرية والمادية التي تمليها طبيعة بيئتهم الدينية والاجتماعية، بل سيكون وبالًا عليهم، وسيكون مصدرًا لتعاستهم وشقاوتهم لا إسعادهم ونهضتهم، فالتشريع الصحيح وليد روح الأمة ونتيجة عرفها وعاداتها، إذ كل فرد أسير قيمه ومبادئه الدينية والاجتماعية.
وإن أهم إفرازات الواقع ودلالاته عدم صلاحية العقل البشري لِئن يكون مصدرًا للتشريع، فالتاريخ يُثبت لنا يومًا بعد يوم أن بِنْيَة العقل ضعيفة وَهْنَة يسهُل غشها وخِداعها والاحتيال عليها، إذ يُمكن تزويد جمع من العقول بمعلومات خاطئة معيبة، أو إغوائها بضلالات فاسدة مُنحرفة، فتقع في الخطأ الفاحش بكل سهولة، وتنقاد للضلال البين بلا أدنى مُبالاة!
بل أثبت الواقع أن العقول مع اجتماعها قد تكون غير قادرة على البحث في الأدوات والأساليب والصفات وظواهر الحوادث وهيئات الناس ومظاهرهم، وعلى مقدار ما أَبْدته هذه العقول من براعة في التعامل مع كم الأحداث، فقد أَبْدت في المقابل عجزًا غير محدود في التعامل مع كيفها، وعلى قدر ما كان يُفترض أن تقوم به إذا تعاضدت مع بعضها من تفكير منطقي رشيد، فقد انزلقت في مهاو وحفر التفكير العاطفي الانفعالي والخيالي الوهمي بلا أدنى حكمة أو بصيرة.
لقد أثبت الواقع بما لا يدع مجالًا للشك أن تطبيق القوانين الوضعية كان ولا زال هو أهم أسباب انتشار الجريمة وازدياد معدلاتها وتنوعها على نحو لم يكن في أسلافنا، وأن تلك القوانين لم تؤد دورها في الوفاء بمتطلبات المُتقاضين، وحل خصوماتهم، وفض نزاعاتهم، فلا هي زجرًا حققت، ولا هي قضايا أنجزت، ولا هي حقوقًا لأصحابها سلمت، بل أدت الثغرات التي تملأ عباءتها إلى اللدد في الخصومات، والمماطلة في الإجراءات، وكثرة الاستئنافات، والامتناع عن أداء الحقوق والواجبات، وزيادة البغي والعدوان، وشيوع الفقر والبُؤْس والحِرمان، وإثارة الفوضى والهمجية، وبث روح الانتقام والثأر لدى المتخاصمين.
إن صلاحية أي تشريع تُقرر على أساس صلاحية قيمه ومبادئه وتجانسها مع الواقع، فالسياسة التشريعية الرشيدة يتعين أن تعتمد على عناصر متجانسة مع البيئة التي تضبطها، فإن قامت علي عناصر متنافرة معها افتقدت الصلة بين النصوص ومراميها بحيث لا تكون مؤدية إلى تحقيق الغاية المقصودة منها، باعتبار أن أي تنظيم تشريعي ليس مقصودًا لذاته، وإنما هو مجرد وسيلة لتحقيق أهدافه المتعلقة بضبط الحياة وإسعاد الناس، وفي هذا الإطار تبرز محاسن الشريعة التي هي من وضع الخالق الذي هو أعلم بأحوال عباده، وأدرى بما فيه صلاحهم وما إليه عاقبة أمرهم، والتي تفردت عن التقنينات الوضعية بسمات وخصائص تجعلها أجدر بالاتباع وأولى بالتطبيق، إذ لا تتحكم في سنها الآراء، ولا تعبث في وجهتها الأهواء.
وليس أدل على ذلك من تعارضها وتناقضها، فالذين يُقدسون القانون ويُدافعون عنه، لا يُقدسون شيئًا واحدًا ولا يدافعون عن شيءٍ واحدٍ، إنما هو متعدد في كلياته فضلًا عن جزئياته، بل متناقض في كلياته فضلًا عن جزئياته، وليس أدل على ذلك من تعارضها وتناقضها، فالذين يُقدسون القانون ويُدافعون عنه، لا يُقدسون شيئًا واحدًا ولا يدافعون عن شيءٍ واحدٍ، إنما هو متعدد في كلياته فضلًا عن جزئياته، بل متناقض في كلياته فضلًا عن جزئياته، فأي قانون يدعون الشعوب لاحترامه وتقديسه! القانون الذي يُجيز زواج الشواذ أم القانون الذي يمنعه؟ القانون الذي يُبيح الطلاق بين الزوجين أم القانون الذي يُقيده أم القانون الذي يمنعه؟ القانون الذي يُبيح التبني أم القانون الذي يُقيده أم القانون الذي يمنعه؟ القانون الذي يُطلق يد المورث في اختيار من يرثه - ولو كان كلبًا - أم القانون الذي يُقيد سلطته ويُحددها؟ القانون الذي يأخذ بعقوبة الإعدام أم القانون الذي يُقيد صورها وحالاتها أم القانون الذي يمنع مطلقًا الأخذ بها؟ القانون الذي يُجيز شرب الخمر أم القانون الذي يُقيده أم القانون الذي يمنعه؟ القانون الذي يصل بالضرائب والرسوم إلى الثلث أم الربع أم العشر؟ الذي يقر بمنح الخاضعين له فوائد على أموالهم وودائعهم مقابل حفظها لهم أم الذي يقتطع منها نظير حفظها؟
وهكذا عشرات ومئات الأمثلة المتعارضة والمتناقضة من القوانين، وكلها يُؤسس لها واضعوها تارةً بالعقل وتارةً بالتجربة، إننا لسنا إزاء قانون واحد يُمكن أن يُحترم أو يُدافع عنه، بل أمام عشرات ومئات القوانين المختلفة باختلاف النُظم المتعددة بتعدد الدول، بل لا يكاد يوجد فعل إنساني واحد تتفق كل الأنظمة على عقوبة مشتركة له فضلًا عن تجريمه، وهذا في حد ذاته ينقض فكرة القانون وضرورته.